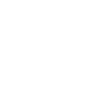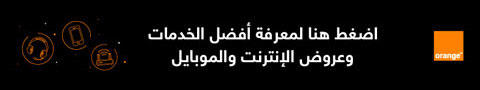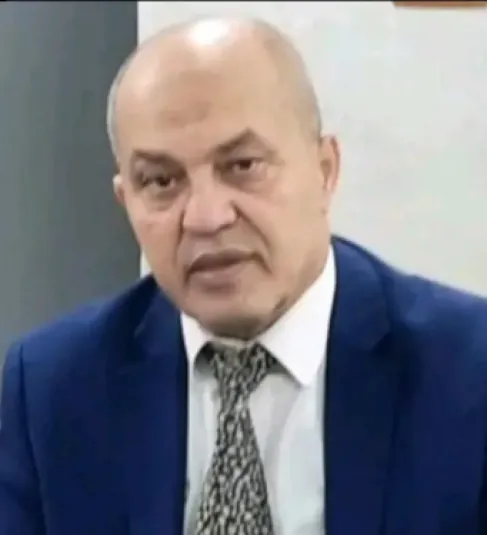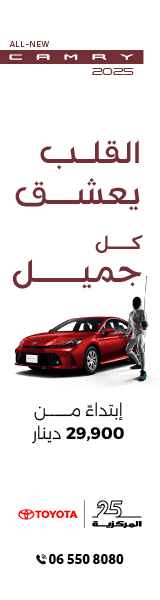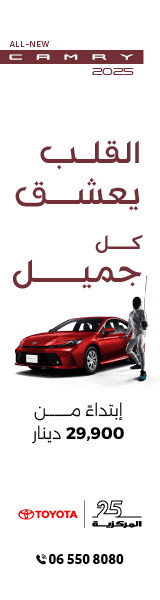أثار القانون الجديد لضريبة الأراضي لعام 2025 جدلًا واسعًا بين المختصين والمهتمين بالشأنين القانوني والاقتصادي. وبينما تسوق الجهات الرسمية هذا القانون بوصفه جزءًا من التحديث الضريبي والرقمنة وتوسيع القاعدة الضريبية، يراه كثير من المهنيين عبئًا ضريبيًا جديدًا في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط معيشية واقتصادية غير مسبوقة.
أولاً: مناقشة مبدأ الاعتراض وأثره القانوني: يشير القانون إلى أن للمواطنين الحق في الاعتراض على التقديرات والضريبة المفروضة، غير أن هذا الحق أصبح في الممارسة العملية وسيلة لتمرير قوانين لا تحظى بالإجماع المجتمعي. فبدلًا من معالجة القوانين بشكل جذري وواقعي، تُترك للمواطن عبء الاعتراض، وهو ما يُعدّ انحرافًا عن مبدأ العدالة التشريعية. فليس من المنطقي أن يُحمّل المواطن عبء مراجعة ومتابعة واعتراض، خصوصًا في قوانين فنية معقدة مثل قوانين الضرائب العقارية. إن تعليق أي انتقاد للقانون بحق الاعتراض يُفرغه من مضمونه، ويحوّله إلى أداة شكلية أكثر من كونه ضمانة حقيقية.
ثانيًا: مشكلة التقدير وغياب المهنية في النصوص: نص القانون على عمليات "تقدير" لقيمة الأراضي والعقارات، وأسند هذه المهمة لأجهزة الأمانة، دون تحديد الجهة المختصة بوضوح، أو اشتراط وجود مقيمين عقاريين محترفين ومعتمدين. المعروف أن أمانة عمان تعتمد على مخمّنين لغايات ضريبة المعارف، وهي وظيفة تختلف جذريًا عن مهنة التقييم العقاري، التي تتطلب مؤهلات أكاديمية وخبرات مهنية وتقنيات تحليل دقيقة.
إن التقدير العقاري من أدق وأصعب المهن التي تحتاج إلى ممارسة حقيقية وشهادات معترف بها دوليًا ومحليًا، لا إلى موظف إداري لديه خبرة خمس سنوات. وهنا نرى أن القانون خلط بين المهني والإداري، وأغفل أهمية أن تكون عملية التقدير قائمة على أسس مهنية دقيقة، مما يهدد بصدور تقديرات غير واقعية أو مجحفة.
ثالثًا: قضية الإعفاءات والتمييز الضريبي: نص القانون على إعفاءات وتسهيلات للفئات الملتزمة بالدفع أو لبعض المؤسسات، غير أن هذه الإعفاءات موجهة غالبًا نحو المقتدرين، في حين حُرم غير القادرين من أي حماية أو معالجة قانونية. وبذلك يكون القانون قد خلق فجوة بين فئة تستطيع الالتزام وفئة تُعاقب بسبب العجز عن السداد، دون مراعاة للواقع الاقتصادي الصعب.
غياب العدالة الاجتماعية في التطبيق: على الرغم من أن القانون أشار إلى منح إعفاءات وتسهيلات ضريبية، إلا أن تحليل النصوص يُظهر أنها موجّهة في الغالب إلى الفئات المقتدرة أو الملتزمة بالسداد المنتظم، دون أن يقابل ذلك أيّ تدبير قانوني يراعي الأوضاع الاقتصادية للفئات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، سواء لأسباب مالية أو معيشية حقيقية. ويُعدّ ذلك تغولًا غير مباشر على جيوب الفئات الأضعف، وتكريسًا لفجوة اقتصادية واجتماعية كان من الأولى معالجتها لا تعميقها.
فالقانون، بصيغته الحالية، أغفل تضمين معايير واضحة للتمييز الإيجابي لصالح غير المقتدرين، كما لم يضع أدوات لتقدير الحالة الاقتصادية للملزمين بالضريبة، أو لاستثناء من يستحق الاستثناء. وبدلًا من تبني مقاربة اجتماعية عادلة، ربط القانون التسهيلات بمدى الالتزام، دون مراعاة لقدرة المكلف أو واقع معيشته، مما يجعله في مواجهة مباشرة مع مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدستور الأردني.
رابعًا: الإشكال الرقمي والتشوهات الإدارية: سبق وأن عانى المواطن الأردني من تجربة التحول الرقمي في أنظمة أمانة عمان، خصوصًا في قضية "الإتاوة"، حيث وُعد الناس بسرعة الإنجاز والشفافية، لكن الواقع أظهر العكس، إذ بقيت الأنظمة بطيئة، وغير متوائمة مع متطلبات العصر التقني. واليوم، يُراد ربط التقدير الضريبي بالقيمة الإدارية، رغم أن كلًا من أمانة عمان ودائرة الأراضي تعترفان بأن القيم الإدارية الحالية مشوّهة وغير دقيقه. فكيف يمكن البناء على أداة معيبة أساسًا؟ وكيف سنخرج من دائرة الاعتراضات والتشوهات المتراكمة؟
خامسًا: التقييم العام للقانون: يُطرح تساؤل جوهري: هل يمكن معالجة الظروف الاقتصادية الصعبة بقوانين أكثر صعوبة؟ وإذا كانت الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات، فهل الحل يكون عبر إثقال كاهل المواطن؟ أم أن الأصل في السياسة الضريبية أن تكون أداة للتوازن لا للتغول؟ يبدو أن المقاربة المتبعة هي: "داوِها بالتي كانت هي الداء"، وهذا بحد ذاته يُعدّ تحديًا دستوريًا واجتماعيًا خطيرًا.
إن القانون الجديد لم يكتفِ بغموض في الصلاحيات، بل أضاف عبارات فنية كـ"التقدير" دون وضع أسس قانونية أو مهنية واضحة لتنفيذها. وإذا كان الخبراء المختصون أنفسهم يواجهون صعوبة أحيانًا في التقدير العادل، فكيف بموظف إداري؟ كما تجاهل القانون انتشار ظاهرة "الاستراحات" والتعديات العشوائية، التي أصبحت مظهرًا غير حضاري، دون أن يضع حلولًا عملية لها.
الخاتمة: إن قانون ضريبة الأراضي بصيغته الحالية بحاجة إلى إعادة نظر جذرية، ليس فقط من حيث التفاصيل الإجرائية، بل من حيث الفلسفة التي تحكمه. فلا يمكن معالجة واقع مأزوم بأدوات مأزومة. وإذا أرادت الدولة فعلاً إصلاح النظام الضريبي، فعليها أن تُسند التنفيذ إلى جهة سيادية وطنية، مهنية ومدربة، تعمل وفق منظور شامل للقطاع العقاري كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة ودول الخليج العربي، بحيث تُدار الأمور برؤية تخطيطية لا جباية عشوائية.
القانون ليس مجرد نصوص، بل هو تعبير عن عقد اجتماعي يجب أن يوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، بين التنمية والعدالة، وبين السيادة والمهنية.