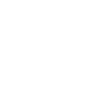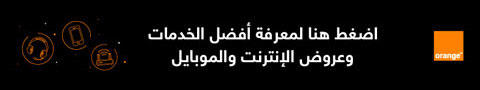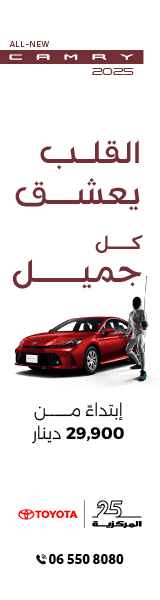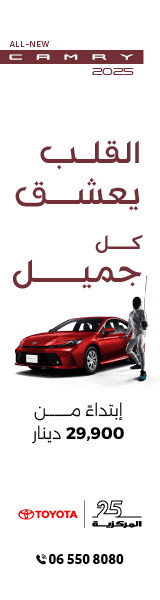رغم أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 لم يُقر بعد، إلا أن التحشيد الإعلامي المحيط به، وتسارع التغطيات الإخبارية لتبرير مضامينه، يوحيان بأنه في طريقه للمرور، وكأن التمرير بات تحصيل حاصل.
في جوهره، يفرض مشروع القانون ضريبة سنوية على الأبنية والأراضي استنادًا إلى “القيمة التقديرية” التي تُحسب تلقائيًا عبر الذكاء الاصطناعي، دون لجان، ودون مراعاة واقعية للقدرة على الدفع أو طبيعة العقار.
صحيح أن النص يضع نسبًا مختلفة بين الأبنية السكنية وغير السكنية، ويمنح خصومات في حال الإشغال من المالك أو أقاربه، لكنّه لا يُميّز جوهريًا بين العقار المنتج وغير المنتج، ولا بين العقار المستغل والعقار الخالي أو الوراثي.
تُفرض الضريبة حتى على الأراضي غير المستغلة، بصرف النظر عمّا إذا كانت تدر دخلًا أم لا، ودون اعتبار للظروف المحيطة بالمالك أو الوريث. فهل الوريث بالضرورة غني؟ وهل أصبحت الملكية الخاصة – بمجرد وجودها – عبئًا ضريبيًا دائمًا؟
وفق مشروع القانون، تُفرض نسبة 0.4% من القيمة التقديرية على الأراضي الخالية التي تقل مساحتها عن 1000م²، و0.2% على ما يزيد عنها. وقد تبدو هذه النسب بسيطة على الورق، لكنها تُفرض سنويًا، وتتراكم، وتترافق مع غرامات وفوائد. أما الإعفاءات، فليست سوى تبرئة ذمة قانونية محاطة بشروط معقدة، ولا تشمل سوى بند “المسقفات”، بينما تبقى رسوم المعارف والصرف الصحي قائمة.
نحن أمام تحول جوهري في فلسفة الدولة تجاه المواطن: من الشراكة إلى الجباية.
يُطلب منك أن تدفع، لا لأنك ربحت، بل لأنك موجود. ويُقال لك بعد ذلك: “كن منتميًا”، دون أن يُقال لك: “كن مُنصفًا في حقك”.
ما زال المشروع في طور النقاش. وما زال الصوت المهني، والوطني، والمواطن، قادرًا على التأثير.
فالعدالة لا تُبنى على خوارزميات التخمين، بل على فهم الواقع، والتوازن بين الحق والقدرة